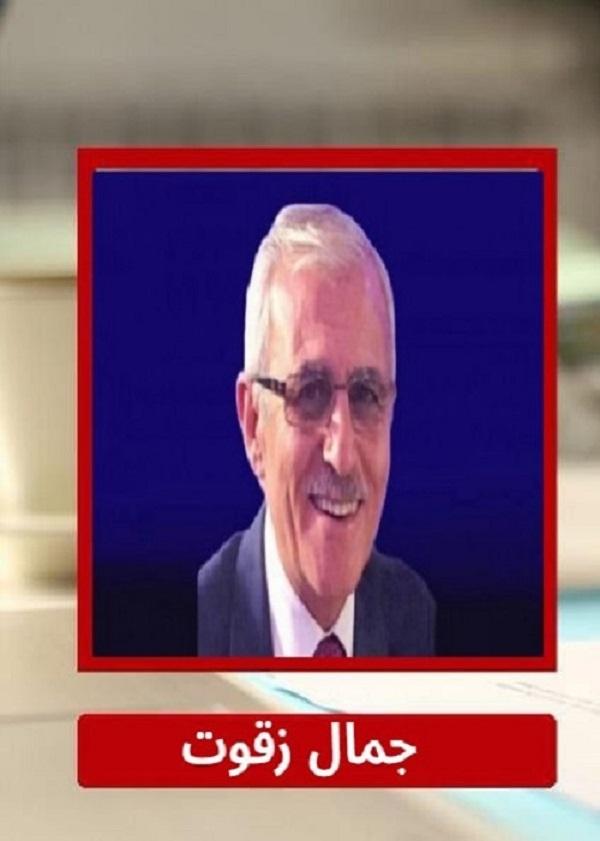الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين 17/11/2025 العدد 1462

|
الصحافة الاسرائيل- الملف اليومي افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس/ ذي ماركر 17/11/2025
تبادل الاتهامات بالتبذير والتجاوز بالمليارات واتباع “ميزانية الظل”
بقلم: ناتي توكر
المعركة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع على ميزانية 2026 لا تشبه الصراعات العادية على الميزانيات بينهما في كل سنة ميزانية. هذه المرة، يعرف الطرفان أن القرار سيؤثر لسنوات على ميزانية الدفاع، وسيؤثر لاحقاً على النفقات المدنية في إسرائيل.
إنهاء الحرب ترك إسرائيل في وضع أمني جديد، يبدو أن المخاطرة تضاءلت في جزء من الجبهات، مثلما أمام حماس في غزة، وحزب الله في لبنان وسوريا، وفي جبهات أخرى، بالأساس إيران.
في التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، كتب مراسل مكتب مراقب الدولة أن رئيس الحكومة نتنياهو لم يعمل حتى الحرب على بلورة نظرية أمنية لإسرائيل. وبعد اندلاع الحرب، ليس للحكومة الحالية أي نظرية متبلورة يشتق منها احتياجات جهاز الأمن وميزانيته.
في تموز الماضي، تم الاتفاق على إضافة لميزانية الدفاع في 2026، عقب تكاليف عملية “عربات جدعون” (الأولى) وعملية “شعب كالأسد”. حسب هذا الاتفاق، كان يمكن أن تصل ميزانية الدفاع في 2026 إلى 95 مليار شيكل. ولكن الخلاف الرئيسي حول الزيادة سيكون في المستقبل، ففضلوا تأجيله.
الآن، تأتي لحظة الحقيقة. الزيادة في 2026 بسبب ما يسمى “نقاشات الأمن الجاري” تكمن في مركز خلاف شديد بين الوزارتين؛ فقد طلبت وزارة الدفاع 144 مليار شيكل، مقابل ميزانية بلغت 163 مليار شيكل في 2025، بما في ذلك المساعدات الأمريكية. المبلغ يشمل زيادة تبلغ 37 مليار شيكل لتمويل تجنيد 60 ألف جندي احتياط في المتوسط في أي وقت خلال السنة، و7 مليارات شيكل من استعداداً لأي تهديد في المستقبل من قبل إيران.
وزارة المالية لا تذكر أرقاماً، لكنها تستخدم كل أدواتهم في محاولة لتقليص الميزانية. تدرك وزارة المالية أن هناك حاجة لزيادة تمويل الأمن الجاري المتزايد، لكنها تريد أن يأتي جزء منها على حساب نجاعة جهاز الأمن.
يعرف الطرفان أنه بعد أن كانت ميزانية الدفاع في 2023 – 2025 استثنائية من حيث حجمها بسبب الحرب، فإن ميزانية 2026 – السنة التي لا يتوقع حدوث معارك فيها – ربما تحدد نفقات الأمن الجاري أيضاً للسنوات القادمة. ميزانية 2026 قد تنبئنا بما هو “الأمر الطبيعي الجديد” في ميزانية الدفاع، وسيكون من الصعب النزول منها بدرجة كبيرة في السنوات القادمة، حتى لو كان هناك هدوء أمني.
خطوط بارزة
المعركة بين الوزارتين وصلت إلى خطوط بارزة عندما أوقف المحاسب العام في وزارة المالية لجهاز الأمن القدرة على تنفيذ تعاقدات جديدة. رغم المنشورات التي فرض بحسبها وقف التعاقدات بسبب تجاوز ميزانية 2025، فهذا أمر تم بسبب تجاوز جهاز الأمن للإنفاق المستقبلي الموجود في ميزانية 2026. وزارة المالية تتهم جهاز الأمن بأنه وقع الآن على عقود لتعاقدات في 2026 تتجاوز المبلغ المصادق عليه.
جهاز الأمن يدير نوعاً من “ميزانية الظل” التي هي غير متزامنة مع الميزانية المقررة له. وفي كل سنة، هناك تجاوز كبير في تعاقدات مستقبلية. على الأغلب، التجاوزات تبدو بمبالغ صغيرة. ووزارة المالية تنجح في تغطيتها من الاحتياطي. أما هذه المرة، تقول وزارة المالية، فالتجاوز كبير، “مليارات كثيرة”، وما لم يتفق على ميزانية الدفاع لسنة 2026 فسيصعب إيجاد مصادر ميزانية لتغطية ذلك.
تحاول وزارة المالية التشكيك في ادعاءات جهاز الأمن ووصفه بأنه جهاز مبذر وعديم المسؤولية. حسب بيانات المالية مثلاً، فإن مساحة المكاتب المتوسطة للموظف في مكتب مدير عام في الوزارات الحكومة هو 18.5 متراً مربعاً. ولكن المساحة لمكاتب مشابهة في جهاز الأمن أكبر بـ 51 في المئة.
إضافة الى ذلك، الفجوة في الأجور والحقوق بين موظفي الحكومة العاديين وبين جهاز الأمن كبيرة. وحتى مع ضباط ليسوا في وظائف قتالية، تبلغ مئات آلاف الشواكل لصالح رجل في جهاز الأمن، الذي خرج إلى التقاعد المبكر في جيل 44 سنة.
-------------------------------------------
هآرتس 17/11/2025
استراتيجياً.. كيف أصبح بن سلمان التهديد الأخطر من إيران على إسرائيل؟
بقلم: تسفي برئيل
مم تخشى إسرائيل أكثر.. من التطبيع مع السعودية وما يرافقه من دفع ثمن فلسطيني، أم من بيع 48 طائرة إف35 الأمريكية، التي ستقلل من تفوقها الجوي في المنطقة، أم من سيطرة الإدارة الأمريكية على شؤون غزة؟
سيزور ولي العهد وحاكم السعودية الفعلي محمد بن سلمان واشنطن، بعد توقف استمر ست سنوات تقريباً. تبدو هذه الزيارة الآن كعاصفة تسونامي تهدد بضعضعة الأسس التقليدية لسياسة إسرائيل. هذه العاصفة قد تضع إسرائيل على مسار مواجهة مع الإدارة الأمريكية “الأكثر ودية” التي كانت لها في واشنطن – التي قد تفضل التحالف مع السعودية على الاعتبارات السياسية والسياساتية لإسرائيل. في الواقع، التهديد السياسي الاستراتيجي الأخطر الذي تواجهه إسرائيل يكمن في الرياض، وليس في طهران أو غزة.
يمكن التقدير بأن بن سلمان (40 سنة)، لن يفاجئ مستضيفه بعزف مقطوعة موسيقية كلاسيكية على البيانو كما فعل في 2015 عندما استضافه جون كيري في بيته، وزير خارجية الرئيس أوباما. كما تعلم في هذه الأثناء أمراً أو أمرين عن قيود قوته بصفته زعيم مملكة لم يقدرها ترامب بشكل خاص. في الحملة الانتخابية في 2015، التي تنافس فيها أمام هيلاري كلينتون، ومنذ ذلك الحين، تعلم ترامب أيضاً شيئاً أو شيئين عن مكانة السعودية وعن قوتها في مساعدته على تحقيق سياسته.
بن سلمان، يحضر إلى واشنطن لاستيضاح الشروط التي عليه استيفاؤها لتحقيق الغلاف الدفاعي الأمريكي الذي خيب أمله عندما هاجمت إيران منشآت النفط السعودية في 2019. يبدو أن المعادلة بسيطة: اتفاق دفاع وطائرات إف35 وربما تعاون لبناء مشروع نووي لأهداف سلمية، مقابل التطبيع، إضافة إلى استثمارات سعودية بمبلغ 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ولكن أضيف منذ 7 أكتوبر بند متفجر بشكل خاص اسمه “دولة فلسطينية”.
إذا كانت السعودية اكتفت حتى اندلاع الحرب بشرط غامض وعبثي عملياً، طالبت فيه “بتحسين ملموس لظروف معيشة الفلسطينيين، فإنه أضافت شرطاً آخر في أيلول 2024، ولم تتراجع عنه حتى الآن. ووفقاً لهذا الشرط، لن تتمكن السعودية من إقامة علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية”. صحيح أن السعودية تدعم خطة ترامب التي تتكون من 20 نقطة، وأنه تم التنسيق معها بمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن أيضاً، لكنها في الوقت نفسه، خلافاً لموقف واشنطن، قادت مع فرنسا أيضاً الخطوة التي أدت إلى اعتراف كاسح من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
قد يكون من الأفضل لبن سلمان أن يفكك “الصفقة السعودية” الى أجزاء، ومن ثم ترسيخ العلاقات بين الدولتين بدون أن تصبحا رهينة لإسرائيل ولبنان وحزب الله وحماس. وقعت السعودية على الإعلان الأمريكي الصادم في يوم الجمعة، إضافة إلى ثماني دول أخرى، الذي يعتبر عملية الأمم المتحدة “مساراً نحو تقرير مصير فلسطيني مستقل ودولة فلسطينية”. ولكن حتى لو أقر مجلس الأمن الاقتراح بصيغته الحالية فمن غير المؤكد أن السعودية ستعتبره يلبي الشرط الأساسي الذي يعيق تحقيق التطبيع، وهذا يرجع أساساً الى عدم وجود التزام أو ضمانة أمريكية لتحقيق الهدف. إضافة إلى ذلك، لم ينطق ترامب حتى الآن عبارة “دولة فلسطينية” ضمن رؤيته لإتمام اتفاقات إبراهيم.
لكن لا يقين بأن القضية الفلسطينية ستتحول الآن لتصبح المحور الرئيسي، الذي بتحريكه تتعلق كل القضايا التي تربط بين واشنطن والرياض. حلف الدفاع مع السعودية قد يتحقق بدون التطبيع، بما يشبه حلف الدفاع الذي منحه ترامب لقطر في أيلول، الذي ينص على أن “الولايات المتحدة تعتبر أي هجوم عسكري ضد أراضي قطر وسيادتها وبناها التحتية المهمة، تهديداً لسلامة وأمن الولايات المتحدة.
الاتفاق لم يتطلب أي مقابل من قطر، لكنه صيغ كأمر رئاسي ولم يحصل على موافقة الكونغرس، ومن ثم هو صالح فقط لولاية ترامب. تسعى السعودية إلى اتفاق بعيد المدى، مرسخ بقرار من الكونغرس، وقد تواجه طلباً يربط هذا الاتفاق بالتطبيع مع إسرائيل، بل ستجعل أي موافقة على بيع طائرات إف35 مشروطة بهذا التطبيع.
في هذا السياق، يجدر التذكير بأن التطبيع لا يعتبر ذخراً استراتيجياً سعودياً، ولخيبة الأمل، أيضاً حكومة إسرائيل الحالية لا تعتبره ذخراً استراتيجياً إذا كان يعني اعترافها بحق الفلسطينيين بدولة. الأمر الذي سيضع حكومة إسرائيل أمام خطر وجودي. المفارقة أنه من أجل إقامة تطبيع، الذي يتشوق ترامب إليه أكثر من حكومة إسرائيل، سيضطر إلى فرضه، ليس على السعودية بل على إسرائيل – أو الدخول إلى حذاء إسرائيل ويعترف بدولة فلسطينية، وبالتالي، توفير الطلب الحاسم للسعودية.
ليس من نافل القول أن ترامب قد قوض بعض الأسس التي كانت تعتبر صلبة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فهو لم يكتف بإجبارها على وقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير محدود تقريباً، بل أصبح حاكماً لغزة فعلياً. وخلافاً لموقف إسرائيل، اتخذ ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع حليفاً، وأصبح يعتبر قطر شريكة استراتيجية رئيسية، وبسرعة أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعامة رئيسية لترامب، وقد يكون شريكاً في إدارة غزة، وأخيراً، رغم قصف الولايات المتحدة لإيران في حزيران، لم تتنازل واشنطن حتى الآن عن إمكانية المضي باتفاق نووي معها. لم يستمع ترامب وبحق إلى موقف إسرائيل ولم يتبناه في أي خطوة من هذه الخطوات. حتى الآن، لا إشارة على نية لدى ترامب لبذل جهد إضافي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا حتى من أجل صديقه العزيز بن سلمان، لكن حكومة إسرائيل تراه بالفعل رئيساً يجب وصفه بأنه مادة خطيرة وغير مستقرة.
من جهة أخرى، قد يحاول بن سلمان إقناع ترامب بأن ما يظهر كعقدة لا تنفصم، بين التطبيع وحلف الدفاع وصفقة شراء طائرات إف35 والمشروع النووي السعودي، هو عبء لا حاجة إليه ويضر بمصالح الدولتين. قد يرى أنه من الأفضل تفكيك “الصفقة السعودية” إلى مكوناتها ومناقشة كل قضية على حدة، ما سيؤدي إلى استقرار العلاقات بين الدولتين على أساس ثنائي مريح، دون اشتراطها بعلاقة إقليمية، بطريقة تجعلهما رهينة لدول ومنظمات مثل إسرائيل ولبنان، وحزب الله وحماس.
------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 17/11/2025
هكذا أصدر “ليفين وقضاته” حكم الإعدام على النظام القضائي في إسرائيل
بقلم: ناحوم برنياع
شهد مصير رئيس المحكمة العليا، إسحق عميت، حدثًا نادرًا يكاد يكون فريدًا في تاريخ القانون: فقد كتب بيديه حكم الإعدام على المؤسسة التي يرأسها. قبل أقل من عامين، وفي قرارٍ بإلغاء مبرر المعقولية، كتب جملةً مؤثرة: “الديمقراطيات تموت في سلسلة من الخطوات، يمكن القول إن كل خطوة منها على حدة لا تؤدي إلى نهاية الديمقراطية، ولكن عند تراكمها، تؤدي إلى تغيير في النظام”.
بمعنى أكثر واقعية: تموت الديمقراطيات تدريجيًا، من حكم إلى حكم، وستضمن المحكمة تمهيد الطريق لها. حدث ذلك في النصف الأول من القرن الماضي في إيطاليا وألمانيا، وحدث في السنوات الأخيرة في بولندا والمجر، ويحدث الآن في الولايات المتحدة. في كل هذه البلدان، أعد قضاة المحكمة العليا الرحلة نحو النظام الآخر، بعضهم بقلق، وبعضهم بفرح، بالاعتماد المسند على القانون والإجراءات والصرامة القانونية. لو درس القضاة المحترمون التاريخ بدلاً من القانون، لحكموا بشكل مختلف.
إن قضية النائبة العسكرية العامة استثنائية لعدة أسباب؛ بدأت بأحداث في “سديه تيمان” وإساءة معاملة أحد المعتقلين، واقتحام القاعدة، وفشل الجيش، وتمتع المجرمين ومثيري الشغب بدعم سياسي واسع مع حملة تحريض عنيفة. وردًا على ذلك، انتقلت النائبة العسكرية العامة، وهي بطل في الجيش الإسرائيلي، من خطأ إلى خطأ، من تستر وخداع واضح للمحكمة العليا إلى محاولتي انتحار وظهيرة من الدراما الوطنية؛ ففُتح تحقيق جنائي، وقرر وزير العدل تحويلها إلى خطوة هامة أخرى في حملته للقضاء على دور المستشارة القانونية والنظام القضائي عمومًا.
من الناحية القانونية، كانت القصة أقل دراماتيكية: فتحت الشرطة تحقيقًا بعد أن اعترفت الشخصية المحورية فيه بالذنب، وحتى هاتفها المحمول عُثر عليه سليمًا. من المشكوك فيه أن كانت القصة كافية لتُملأ حلقة واحدة من مسلسل تلفزيوني بوليسي. كما خفت الضجة المحيطة بالنائبة العسكرية العامة: فقد استنفد ليفين وروتمان وزملاؤهما المكاسب التي جنوها من عثراتها. انتقلوا إلى المحطة التالية.
هذا النوع من التحقيقات يتطلب محاميًا مشرفًا. لا يُفترض أن يكون لديه الكثير من العمل، لكن القانون هو القانون. وهكذا نشأت المسألة التي قسمت الدولة إلى قسمين. من الذي سيعين المشرف على تحقيق الشرطة. المستشارة القانونية هي من يعين، لكن الشرطة قد تستدعيها للتحقيق، وهي أيضاً قد تستدعى للتحقيق. في حكومة أخرى كانت المشكلة ستحل بتعيين مُتفق عليه، يكاد يكون عرضيًا، ولكن الأمر مع وزير العدل لفين مختلف. وهكذا انتهى بنا المطاف في محكمة العدل العليا.
كان بإمكان قضاة الهيئة الاختيار بين مسارين، أحدهما متوقع وروتينيّ ومريح: يغوصون في القانون، ويأخذون منه ما يبدو مناسبًا، ويغلّفونه بقيود تبدو مقبولة للجمهور، ثم يطوون الصفحة؛ أما المسار الثاني فهو أكثر إلزامًا: العمل على أساس أن القضية المعروضة عليهم جزء من صورة أكبر بكثير. لا يُبالي يريف لفين بمن سيشرف على التحقيق في قضية النائبة العسكرية العامة- فهو مهتم بالتوجه السائد.
لقد أوضحت طريقة إجراء جلسة المحكمة الأسبوع الماضي للجميع اتجاه القضاة. عندما شاهدتُ الجلسة، تذكرتُ المحكمة العليا التي كان يقودها شمغار وبراك. ماذا سيفعل شمغار في مواجهة وزير عدل لا يعترف به، ويقاطع مؤسسة الاستشارات القانونية؟ سيلتقي برئيس الوزراء ويوضح له، بأدب، أن ليس هذا هو أسلوب وزير عدل في دولة إسرائيل. لن يسمح لعضو الكنيست تالي غوتليف بالتصرف بعنف داخل المحكمة. لن يتوسل إلى الأطراف للتوصل إلى اتفاق. لا يُفترض بالقضاة أن يتوسّلوا، لا في المحكمة المركزية ضد نتنياهو، ولا في المحكمة العليا. إذا أصرّ الأطراف على رفضهم، فسيؤجل الجلسة حتى يهدأوا. وستقوم الشرطة بعملها في هذه الأثناء.
لقد اختار القضاة غضّ الطرف عن الصورة الكبيرة. أو قد تكون الصورة الكبيرة مقبولة لديهم أو لا تزعجهم. في صراع الانقلاب، غالبًا ما تُعرف المحكمة العليا بكلمة قوية: “الحصن”. المحكمة العليا هي الحصن الأخير، الحصن الذي إذا سقط، سيسقط كل شيء آخر. ربما أبالغ، لكنه يُذكرني بمكانة كلمة “عائق” حتى السابع من أكتوبر: فالجدار على حدود غزة لا يُجتاز؛ والجدار رادع؛ وسيبقى إلى الأبد. أغمض من كان يُفترض بهم أن يكونوا حراس الجدار أعينهم عن رؤية ما كان يتبلور خلفه. ثم ظهرت حركة “النُحبة”.
-------------------------------------------
هآرتس 17/11/2025
إسرائيل أمام جملة تحديات: “إف35” بدون تطبيع وإملاءات واشنطن.. وبند الدولة الفلسطينية
بقلم: عاموس هرئيل
السيناريو الأكثر قلقاً كما تراه إسرائيل في الفترة القريبة لا يتعلق فقط بحصول السعودية على طائرات حربية أمريكية من نوع إف35، بل بإمكانية ألّا يتم الأمر في إطار صفقة تشمل التطبيع بين إسرائيل والسعودية واعتراف ضبابي من قبل إسرائيل بحلم الدولة الفلسطينية. بزيارة وزير العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، تطرح تقديرات حول صفقة شاملة يدفع بها ترامب قدماً، لكن علاقة الإدارة الجمهورية مع العائلة المالكة السعودية قريبة جداً إلى درجة أن يمنح ترامب الرياض هذه الهدية حتى بدون المطالبة بمقابل فوري لها بعملة مهمة بالنسبة لإسرائيل.
قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، وقفت إسرائيل والسعودية على شفا تفاهمات، في إطار مبادرة إدارة بايدن لعقد اتفاق بعيد المدى بين واشنطن والرياض. طلب بن سلمان من الإدارة الديمقراطية حلف دفاع على صيغة الناتو وسلاح متطور ومساعدة في إنشاء مشروع نووي مدني. في حينه، طلب تأييد رئيس الحكومة نتنياهو، لتمرير الاتفاق في الكونغرس بمساعدة دعم الجمهوريين. إسرائيل ساومت الأمريكيين، لكن الطرفين قدرا أن هناك احتمالية جيدة للتطبيع. في 8 تشرين الأول 2023 خطط لعقد جلسة حاسمة لدى نتنياهو بهذا الشأن، لكنها جلسة لم تعقد. وتجمدت الاتصالات فوراً بعد 7 أكتوبر. بأثر رجعي، قال عدد من كبار قادة حماس إن قرار قيادة المنظمة في غزة شن الهجوم كان مرتبطاً أيضاً بمحاولة لإفشال التطبيع.
تسعى إدارة ترامب إلى اتفاق مشابه، بتغييرات طفيفة، منذ أن أدى الرئيس القسم في كانون الثاني الماضي. من ناحية ترامب، سيكون هذا استكمالاً ممتازاً لاتفاقات إبراهيم، التي اعتبرها ذروة سياسته الخارجية في ولايته الأولى. في الخلفية، اعتبارات أهم: توقعات لعقد صفقات ضخمة في المجال الأمني وفي مجال المخابرات والتكنولوجيا، التي ستكون مفيدة للولايات المتحدة، لكن يبدو أنها ستفيد الصناديق والشركات المرتبطة بعائلة ترامب. في نهاية ولايته الأولى، كان ترامب ينوي ربط اتفاقات إبراهيم بتزويد طائرات “اف 35” للإمارات. نتنياهو راوغ، لكنه عملياً أعطى موافقته. في هذه الأثناء، خسر ترامب انتخابات 2020، وظهرت مشكلات أخرى، ولم تتم الصفقة المصادق عليها. الآن، يبدو أن ترامب يعتبر صفقة “اف35” عاملاً رئيسياً في السياسة الخارجية الأمريكية: السعودية، ومثلها تركيا، مشمولة الآن في قائمة الزبائن المحتملين.
هذا يتناقض مع سياسة الـ كيو.ام.إي التي تلزم الإدارات الأمريكية منذ أكثر من خمسة عقود أو أكثر بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط. طائرات إف35، كما ثبت في السنتين الأخيرتين بشكل خاص، هي سلاح ذو أهمية استراتيجية. استخدامها ساعد إسرائيل في ترسيخ التفوق في كل الساحات أثناء الحرب في إيران، واليمن، وسوريا، ولبنان.
المشكلة أن قدرة نتنياهو على المساومة أمام ترامب انخفضت جداً. فقد أرسل الرئيس طائرات لقصف المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، ونجح في تحرير المخطوفين الأحياء وإعادة جميع الجثث، باستثناء ثلاث جثث، من غزة. في المقابل، يطالب بامتثال نتنياهو لخططه ونزواته أيضاً. ترامب هو الذي فرض على نتنياهو وقف الحرب في غزة الشهر الماضي، وقبل ذلك وقف الحرب في إيران في حزيران الماضي. لا يوجد الكثير من الأمور التي يمكن لنتنياهو قولها له، خصوصاً بصورة علنية. في هذه الأثناء، السعوديون غير متحمسين للمضي بالتطبيع إزاء أفعال إسرائيل في القطاع، وصحوة الرأي العام لديهم لصالح الفلسطينيين. ربما يحصل ولي العهد السعودي على ما يريده بدون المضي بالتطبيع بصورة فعلية (ربما يحتفظ ترامب بذلك لوقت لاحق، كورقة ستساعد نتنياهو سياسياً في الجبهة الداخلية قبل الانتخابات للكنيست في السنة القادمة).
استمرارية ذلك موجودة في مبادرة يدفع بها الأمريكيون الآن في مجلس الأمن. مشروع القرار يتضمن خطة ترامب لغزة، ويشمل بنداً يتحدث بشكل عام عن خلق مسار موثوق لدولة فلسطينية. في الحقيقة، عاد نتنياهو وأعلن أمس بأنها لن تقوم ولن تكون. ولكن الطريقة التي أطال بها الحرب لسنتين وامتنع عن مناقشة ترتيبات اليوم التالي، ستعطي للفلسطينيين الآن إنجازاً لا بأس به في الساحة الدولية، حتى لو كان الحديث الآن عن عملية رمزية فقط.
مثلما كتب ينيف كوفوفيتش في “هآرتس” يوم الجمعة، البنتاغون يملي على الجيش الإسرائيلي خطواته في القطاع بشكل مباشر. وهي خطوات لا تتم بالتشاور بين الطرفين، بل يتم نقلها كطلبات، ويتوقع من إسرائيل أن تلبيها. في غضون ذلك، استيعاب قوة متعددة الجنسيات في غزة يتقدم بشكل بطيء نسبياً؛ فالدول الأجنبية لا تقف في الطابور لتعريض حياة جنودها للخطر. حماس هي الرابح من هذا الوضع المؤقت، فهي بذلك ستعيد بناء قوتها العسكرية وتحدث سيطرتها بالتدريج على الجمهور في القطاع. ثمة فجوة آخذة في الاتساع بين الطريقة التي تصف فيها الحكومة نتائج الحرب، والإشارات المتراكمة من الواقع.
-------------------------------------------
معهد السياسة والاستراتيجية IPS 17/11/2025
إسرائيل في ظل غياب “اليوم التالي”.. بين السؤال الإقليمي وأوهام اليمين وضياع الفرصة
بقلم: طاقم المعهد برئاسة اللواء (متقاعد) البروفيسور عاموس جلعاد
نجح الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في توجيه ضربة قاصمة لتحالف الشر في جميع جبهات القتال السبعة. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى استراتيجية لإرساء أمن طويل الأمد. حتى الآن، فشلت الحكومة الإسرائيلية في صياغة سياسة لما بعد “اليوم التالي”، ما أدى إلى خلق فراغ، ملأته الإدارة الأمريكية بكل قوتها. من جهة، لهذا الأمر نتائج إيجابية تتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وعملية إعادة الرهائن القتلى، ووقف الحرب في غزة، وتوطيد العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، واحتمال تحقيق انفراج دبلوماسي مع الدول العربية. من جهة أخرى، قد يؤدي هذا التطور إلى أضرار جسيمة، مثل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بمشاركة دول معادية، بقيادة محور تركي قطري داعم لجماعة الإخوان المسلمين، واستمرار وجود حماس بصيغة جديدة في غزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال الإضرار بالتفوق النوعي للجيش الاسرائيلي، من خلال نقل قدرات عسكرية غير مسبوقة إلى الدول العربية. في الخلفية، تُبذل جهودٌ من إيران وحزب الله لاستعادة القدرات العسكرية المتضررة خلال الحرب.
على الصعيد الداخلي، تشهد إسرائيل بقيادة الحكومة الإسرائيلية سلسلةً من العمليات الهدامة التي تُلحق الضرر بالمناعة الوطنية والاجتماعية، التي يتشكل ركيزةً أساسيةً من ركائز الأمن القومي الإسرائيلي. ويشمل ذلك استمرار الانقلاب القضائي وإلحاق الضرر بالمؤسسات القضائية، والحرب على وسائل الإعلام في البلاد، والتدخل في أنشطة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، وغيرها.
يعني ذلك أنه بدون سياسة مُحدثة، قد تُجر إسرائيل إلى وضعٍ تُملى فيه التطورات الميدانية من الخارج، وليس بالضرورة بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، مما يُضر بمكانتها ويُقوّض إنجازاتها العسكرية على جميع الأصعدة.
القوة متعددة الجنسيات في غزة
تبوأت القضية الفلسطينية مكانةً مركزيةً على الأجندة العالمية والإقليمية، ويتزايد تدويل أزمة غزة عمليًا. ويتم ذلك بإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، قوامها قوات إسلامية، مدعومة بقرار من مجلس الأمن. ويُخشى من أن قوةً بهذا التشكيل الناشئ لن تعمل بحزم على نزع سلاح حماس، ولن تُخرجها من القطاع. في الواقع، تُخاطر إسرائيل بتكرار نموذج اليونيفيل في لبنان، الذي غضّ الطرف عن تعزيز قوة حزب الله. إضافةً إلى ذلك، ستُقيّد حرية عمل الجيش الاسرائيلي بشدة، خاصةً مع امتناع حماس تجديد الأعمال الإرهابية وإطلاق النار على إسرائيل.
فضلا عن ذلك، من المرجح أنه بدون مشاركة السلطة الفلسطينية في عمليات إعادة الإعمار والإدارة في قطاع غزة، ستمتنع السعودية ودول الخليج عن استثمار المبالغ المالية، المُقدّرة بعشرات المليارات من الدولارات، اللازمة لإعادة إعمار القطاع. في مثل هذا السيناريو، قد تبقى لحماس بنية تحتية حاكمة في غزة، مدعومة من تركيا وقطر.
إن تفاقم الجرائم القومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أدت حتى إلى انتقادات من وزير الخارجية الأمريكي، إلى جانب استمرار سياسة الوزير سموتريتش الأحادية الجانب في توسيع المستوطنات والإضرار بالوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، قد يؤدي إلى تدويل الصراع في هذه المنطقة أيضًا، خاصة إذا نجح نموذج غزة. وهذا قد يُسرّع أيضًا من المطالبة في النظام الدولي والإقليمي برؤية الدولتين.
تشكيل محور سني يدعم الإخوان المسلمين
تُجسّد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان مطلوبًا للعدالة حتى قبل عام تقريبًا، والمعروف باسم الجولاني، إلى واشنطن أفقًا جديدًا لمحور سني، بتشجيع من الولايات المتحدة ودعم من قطر وتركيا. من ناحية أخرى، قد يؤدي تعزيز المحور التركي القطري إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، ويضع صعوبات جمة أمام جهودها لإعادة فتح سفاراتها. هذا، بطريقة قد تُهيئ حتى فرصًا لتعاون محدود بين إسرائيل وتركيا ضد إيران. من ناحية أخرى، تُظهر قطر، وخاصة تركيا، موقفًا عدائيًا تجاه إسرائيل، كما يتضح من قرار أردوغان إصدار أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا رفيع المستوى لمسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية في غزة. لذلك، فإن تعزيز نفوذ أنقرة في الشرق الأوسط، وخاصةً مشاركتها المحتملة في إعادة إعمار قطاع غزة، قد يُقيّد قدرة إسرائيل على تحقيق أحد أهدافها: أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حماس ونزع سلاح قطاع غزة.
إعادة بناء قدرات المحور الإيراني
على الصعيد الإقليمي، من الواضح أن المحور الإيراني يبذل جهودًا كبيرة لإعادة بناء قدراته. ومن أهم مظاهر ذلك استمرار الدعم العسكري والمالي الإيراني لحزب الله لتحقيق هدفين رئيسيين: أولًا، ضمان عدم نجاح الحكومة اللبنانية في خططها لإضعاف حزب الله سياسيًا وتفكيك قدراته العسكرية. ثانيًا، مساعدة التنظيم في عمليات إعادة الإعمار، ليتمكن من إعادة بناء نفسه وتشكيل تهديد لإسرائيل كجزء من معادلة الردع.
في المجال النووي، تشير منشورات مختلفة إلى أن إيران تسعى لإعادة تأهيل المواقع التي تعرضت للهجوم. حتى إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، حذّر من تجنب إيران التعاون مع مفتشي الوكالة، الذين لم يحصلوا على إذن بدخول المنشآت النووية، وأن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لا يزال غامضًا. في الوقت نفسه، تواصل إيران رفض العودة إلى مسار التسوية مع الولايات المتحدة، وتعارض جميع المطالب بوقف التخصيب تمامًا. في مجال الإرهاب، تواصل إيران أيضًا محاولاتها لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم، كما تجلّى في محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك.
العلاقات الإسرائيلية الأمريكية
على الرغم من المساعدات الأمريكية الواسعة لإسرائيل والتعاون الأمني والعسكري الوثيق، من المرجح أن تشهد العلاقات الثنائية توترات متزايدة في الأسابيع المقبلة. ويتجلى هذا بشكل خاص في ضوء الانتقال من إطلاق سراح الرهائن إلى المرحلة الثانية من نشر القوات الدولية، وواقع الاستيطان في قطاع غزة. يُضاف إلى ذلك رؤية حل الدولتين كشرط لتحقيق رؤية ترامب الاستراتيجية، وإمكانية زيادة التعاون العسكري بشكل كبير بين الولايات المتحدة والدول العربية.
في ظل هذه الخلفية، ثمة تحولات داخلية عميقة في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل. وينضم انتخاب ممداني عمدة لنيويورك إلى سلسلة طويلة من استطلاعات الرأي العام التي تشير بوضوح إلى تضرر كبير في مكانة إسرائيل بين مؤيدي الحزب الديمقراطي، وبين الشباب في الحزب الجمهوري. هذا الأمر قد يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لمتانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين على المديين المتوسط والطويل. وقد يكون له تأثيرٌ بالغٌ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مع بدء المناقشات العام المقبل حول تجديد اتفاقية المساعدة الأمنية متعددة السنوات، والمقرر انتهاؤها في عام 2028.
في السياق الأوسع، قد يُشجّع انتخاب ممداني التوجهات المعادية لإسرائيل، ويُعطي دفعةً لظاهرتي نزع الشرعية ومعاداة السامية في الولايات المتحدة وحول العالم، اللتين تصاعدتا بالفعل خلال العامين الماضيين، مما سيُفاقم المخاطر التي تواجه الجاليات اليهودية والتحديات التي تواجه دولة إسرائيل.
زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة
تُحمل الزيارة المُخطط لها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 تشرين الثاني، إمكانية تعميق التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، وحتى النووية. في الواقع، تعكس الزيارة توجهًا عربيًا، بقيادة السعودية، نحو تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، متجاوزةً إسرائيل. تُعدّ هذه الدول خططًا لتعزيز قدراتها العسكرية، دون أي صلة أو شرط بالترويج لاتفاقية تطبيع أو توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم.
يُطرح على جدول الأعمال إمكانية توقيع اتفاقية دفاع، لتعزيز صفقات ضخمة لبيع أنظمة أسلحة متطورة، وفي مقدمتها طائرات F35 المقاتلة. وهذا قد يُشكّل تحديًا للتفوق النوعي للجيش الإسرائيلي، المُكرّس أيضًا في القانون الأمريكي. يُضاف إلى ذلك طلبات السعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمساعدة أمريكية. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي سبق أن صرّح في مناسبات عديدة بأنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، فإن السعودية ستسعى جاهدةً للحصول عليها.
الأهمية والتوصيات
إن الإنجازات العسكرية الباهرة التي حققها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تُهيئ الظروف الملائمة لوضع استراتيجية تُحوّل هذه النجاحات إلى ثمار سياسية تُعزز قوة دولة إسرائيل الشاملة. ولتحقيق ذلك، لا بد من صياغة سياسة سريعة تتضمن:
1-أولاً وقبل كل شيء، استكمال عملية إعادة جميع الأسرى القتلى، وإدراك أن حرب غزة قد انتهت فعلياً نتيجةً للقرار الأمريكي والإجماع العربي الدولي.
2-التخلي عن جميع أفكار تهجير سكان غزة، والسيطرة على الأراضي، وإقامة حكم عسكري. فهذه الأفكار قد تُفاقم العلاقات مع الدول العربية وتُلحق المزيد من الضرر بمكانة إسرائيل الدولية.
3-الاندماج في خطة الرئيس ترامب السياسية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع منع الوجود التركي والقطري في المنطقة، لأن ذلك قد يُشكل صعوبات حقيقية في عملية تفكيك قدرات حماس.
4-تعزيز حضور السعودية والإمارات ومصر في غزة، بما يُسهم في تعميق العلاقات الثنائية الاستراتيجية معها.
5-مواصلة سياسة القضاء على الإرهاب في الضفة الغربية، إلى جانب إنهاء سياسة إضعاف السلطة الفلسطينية. وهذا سيُتيح أيضًا تعزيز منظومة العلاقات مع الأردن، الذي يُشكل جبهة خلفية استراتيجية لدولة إسرائيل.
6-نشاطٌ يمنع حزب الله من استعادة قوته. يجب إيجاد آلية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تجمع بين استمرار النشاط العسكري ونشاط الحكومة اللبنانية الحازم ضد المنظمة.
7-منع إيران من تعزيز القوة الذي تسعى إليه. ولتحقيق ذلك، من الضروري صياغة رد عسكري، إلى جانب تعميق التحالف الإقليمي مع الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة. وقد تجلّت أهمية هذا التحالف عمليًا خلال الهجمات الإيرانية على إسرائيل.
-------------------------------------------
معاريف 17/11/2025
اصطدام تكتوني سياسي في الشرق الأوسط هذا الأسبوع!
بقلم: عميت يغور
نظرية "صدام الحضارات"، التي قدّمها عالِم السياسة الأميركي، صموئيل هنتنغتون، تقول، إن الهوية الثقافية والدينية ستكون المصدر الرئيسي للصراعات في العالم، بعد الحرب الباردة. لقد رأى هنتنغتون أن الحضارات، في عصر ما بعد الحرب الباردة، ستشكل القوة المحركة الأساسية في العلاقات الدولية: فالناس يعرّفون أنفسهم وفق انتمائهم العرقي والديني، وبالتالي ينظرون إلى علاقاتهم بالآخرين من مجموعات عرقية، أو دينية مختلفة، من خلال ثنائية "نحن"، في مقابل "هُم".
تخلق هذه الفوارق خلافات بشأن مسائل متنوعة، وتؤدي إلى خطوط تصدُّع حضارية لا مفرّ منها، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمحاولات الغرب نشر قيَمه حول العالم، أو في محاولات الإسلام "المتطرف" و/أو السياسي (بعضه من مدرسة "الإخوان المسلمين") السيطرة على مراكز القوة في الغرب.
بهذا المعنى، بات واضحاً للجميع أن ما نشهده، اليوم، في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل هو بالضبط ذلك الصدام الذي تحدّث عنه هنتنغتون، لكن الجديد هو أنه إذا ركزنا على العالم العربي فسنكتشف حرباً مشابهة داخل الإسلام نفسه. نشهد، الآن، صدام حضارات بشأن المكانة والقوة في الشرق الأوسط بعد الحرب، وفي ظل نظام إقليمي جديد تقوده الولايات المتحدة بشكل شبه كامل (PAX AMERICANA 2).
الحضارة "أ": محور المقاومة الشيعي
يشمل إيران و"حزب الله" و"حماس"، المنهمكين في هذه الأيام في جهود إعادة بناء مكثفة، وفي حرب إعلامية، ومحاولات فتح جبهات "إرهابية" جديدة، مع السعي للحفاظ على مكانتهم الإقليمية (يقوم وزير الخارجية الإيراني بجولات مكوكية من دون توقّف)، وبمساعدة روسيا والصين.
الحضارة "ب": محور الإسلام السّني "المتطرف"
يشمل قطر وتركيا، اللتين تحاولان الحلول محل محور المقاومة الشيعي، وتحتلان مواقعه، وخصوصاً بشأن الموقف المعادي لإسرائيل، لكن باستخدام منصة "الإخوان" (التغلغل السياسي والاجتماعي والاقتصادي)، أكثر من استخدام مسار "حماس" القائم على "الإرهاب".
الحضارة "ج": الدول العربية السّنية المعتدلة
وتشمل السعودية والإمارات والأردن ومصر، مع تذبذُب مصر بين تهديد "الإخوان" لأمنها القومي وبين المكاسب السياسية التي يمنحها لها استمرار حُكم "حماس" في غزة (تهدئة سيناء، عبر اقتصاد التهريب وتحويل اهتمام إسرائيل بعيداً عنها). إن هذا المحور (على مستوى القيادة، وليس الشعوب) ينظر بعقلانية، ويريد مكاسب اقتصادية تساعد على استقرار أنظمته ومنع النفوذ الخارجي، وفي الأغلب لا يتحرك من منطلقات دينية (السعودية نفسها تمرّ بمرحلة تغيير).
من هذه الزاوية يمكن فهم الأسبوع الحاسم، والاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي ترامب؛ فالسعودية تدخل إلى الاجتماع، وهي بحاجة إلى خطوات وترتيبات تساعدها على تعزيز مكانتها في النظام الإقليمي الجديد. والطريق إلى ذلك، من وجهة النظر الأميركية، تمرّ عبر الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" والتطبيع الرسمي مع إسرائيل (الأمر الذي كان قريباً جداً من التحقق قبل 7 أكتوبر).
وفي هذا السياق، يجب أيضاً فهم الاجتماع الذي عُقد، الأسبوع الماضي، مع الرئيس السوري؛ فسورية، بموقعها الجغرافي وإمكاناتها، هي ساحة المعركة المادية الرئيسة التي تتصادم فيها حالياً حضارات الشرق الأوسط. لقد انتُزعت من يد محور المقاومة الشيعي، ونحن، الآن، في قلب معركة شرسة بين السعودية وتركيا على مَن ستكون الأكثر تأثيراً في سورية بعد الحرب، ومَن سيقود عملية إعادة الإعمار ذات المكاسب الاقتصادية والسياسية الهائلة.
لكن مَن سيحدد اتجاه سورية هو ترامب. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم الجهد التركي الخاص في التسوية بخصوص غزة (بدافع رغبتها في الانخراط المباشر في الموضوع الفلسطيني)، ومن الجهة الأُخرى الالتزامات السعودية حيال استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.
هناك مساران محتملان في الهيكل الاقتصادي الإقليمي الجديد الذي تحاول إدارة ترامب دفعه:
- من الهند، عبر الإمارات والسعودية، وصولاً إلى إسرائيل، كمخرج بحري نحو أوروبا.
- من الهند، عبر دول الخليج، إلى الأردن، ثم شمالاً إلى تركيا، أو عبر آسيا الوسطى نحو تركيا، كمخرج برّي إلى أوروبا. وتحاول تركيا ترسيخ هذا المسار حالياً، من خلال اتفاقيات تشمل إنشاء خطوط سكة حديد، ومن الواضح أن ترامب يفضل المسار الأول، بشرط التعاون السعودي – الإسرائيلي، والذي يتطلب انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.
ولدى السعودية ميزة لا تملكها تركيا، وهي غياب العداء الأيديولوجي لليهود، وعدم منح الملاذ لمنظمات مثل "حماس"، حيث سيحاول ترامب، حسبما اعترف، دفع السعودية إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، في خطوة قد تفجّر النظام الإقليمي القديم، وتؤثر في الوضع في غزة وسورية وغيرهما، وأحد أسباب هجوم 7 تشرين الأول كان توقُّع اقتراب توقيع السعودية.
من المؤكد أن السعودية ستطلب طائرات F-35 وتحالفاً دفاعياً، وربما تطلب أيضاً برنامجاً نووياً مدنياً. ويبقى السؤال: ما الثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة وإسرائيل، في مقابل دخول السعودية الفوري في الاتفاقيات؟
هذا الأسبوع، قد يمرّ الاصطدام التكتوني في الشرق الأوسط بنقطة تحوُّل إذا أعلنت السعودية استعدادها للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لكن تبقى ملاحظة مهمة: يجب أن نتذكر طبيعة السعودية وتاريخها، والتعامل معها من منظور مصالح باردة، وعدم تصديق كل ما يقال من دون رقابة ميدانية على دورها في إعادة إعمار سورية وغزة.
-------------------------------------------
هآرتس 17/11/2025
مشروع الاستيطان يجب إنهاؤه
بقلم: عودة بشارات
بعد الانقلاب في العراق في تموز 1958، اقترح رئيس الأركان في حينه حاييم ليسكوف على دافيد بن غوريون احتلال جزء من الضفة الغربية، لكن الأخير تردد. وقد كتب في مذكراته: "هذه المرة هم لن يهربوا".
أما الرغبة في احتلال الضفة الغربية، فكانت تقف أمامها اعتبارات مهمة. أولها الخوف من السيطرة على مليون عربي"، كتب ميخائيل بار زوهر، كاتب السيرة الذاتية لبن غوريون. بن غوريون شعر بخيبة الأمل عندما لم يهرب سكان غزة في حرب شبه جزيرة سيناء التي اندلعت قبل سنتين من ذلك، كما حدث في 1948. لكن رغم التقدير الكبير لـ"العجوز" من قبل ورثته الشباب، إلا أنهم كسروا كلمته، وفي حزيران 1967 قاموا باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وخوف بن غوريون تحقق.
بعد بضع سنوات كتب رئيس أركان تلك الحرب، إسحق رابين، الذي أصبح بعد ذلك رئيس الحكومة وقتل على يد يميني متطرف، في كتابه بعنوان "مذكرات الخدمة": "غوش إيمونيم هي ورم في جسد الديمقراطية الإسرائيلية".
بعد عام 1967 اجتاحت البلاد موجة نشوة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوطنات. في النسخة السابقة، بعد إقامة الدولة، كان أبطال الاستيطان علمانيين وكتبوا على رايتهم شعارات الاشتراكية وأخوّة الشعوب.
بالطبع، تجاهلت الشعارات العرب الذين تمت مصادرة أراضيهم، وكثيرون اعتقدوا أن هذه القوة ستنتصر أيضًا على موجة الاستيطان الثانية هذه المرة في الضفة، لكن الواقع كان مختلفًا. فبدلاً من الطلائعيين وأصحاب الغُرّة الجميلة، تولى القوميون المتعصبون والمسيحانيون زمام المبادرة.
من جهة أخرى، الفلسطينيون، رغم فظائع الحرب، تمسكوا بأرضهم. فقد تعلموا شيئًا من نكبة 1948. هذا الأمر خلق معضلة أمام المحتلين الجدد، ومن أجل أن يظهروا بمظهر جيد فقد بدأوا يتحدثون عن احتلال متنور وجسور مفتوحة.
ولكن كما هو معروف، فإن الاحتلال لم يأتِ لإظهار وجهه الجميل، هدفه كان طرد أكبر عدد من الفلسطينيين وتوطين اليهود مكانهم. كون العرب غير مستعدين للمغادرة ليس المشكلة الوحيدة.
بن غوريون انتبه إلى موضوع لا يقل أهمية عن ذلك وقال إن "المشكلة هي النقص في اليهود، وليس النقص في المساحة".
ولكن المتعصبين الموجودين الآن على رأس هرم الحكومة لا يفهمون أقواله التي قالها قبل سبعين سنة. هم يريدون التوسع حتى نهر الليطاني، والنهمون منهم يريدون الوصول إلى النيل والفرات. كل هذه الشهية تستيقظ في الوقت الذي لا ينجحون فيه في إقناع الشباب اليهود (والعرب أيضًا) بالبقاء في الجليل.
المشكلة هي أنه لا يوجد زبائن للمستوطنات. الناس يبحثون عن مراكز حضرية تضج بالنشاط، بالأساس تل أبيب والمركز. الإسرائيليون الآن يتجمعون في مساحة تم تخصيصها لـ "الدولة اليهودية" في خطة التقسيم. اليهود الذين جاءوا من أوروبا، من قلب الحداثة في أوروبا، لا تجذبهم الضواحي.
لكن إذا كان يمكن تعزية النفس فلنقل إن هذه هي حال العالم. لقد طوت الدول العظمى راية الكولونيالية قبل ثمانين سنة، وحينها تذكرت الصهيونية رفعها. المثل العربي يقول: "رايح على الحج والناس مروحة". أين هي تلك الأيام، حيث كانت الجموع تحتفل بإقامة مستوطنة: رؤساء حكومات، ووزراء، ووجهاء، جميعهم كانوا يذهبون بملابس احتفالية لوضع حجر الأساس لمستوطنة معزولة.
ما الذي نراه الآن؟ زعران ملثمون، يحملون العصي، والمسدسات، وصهاريج الوقود والتراكتورات الصغيرة، يحرقون ويقتلون ويصيبون، ولا يوجد من يوقفهم، وإذا تم اعتقالهم فبعد فترة قصيرة يُطلق سراحهم. الدكتور شاؤول أريئيلي كتب بأن مشروع الاستيطان يوجد في "جمود عميق في أفضل الحالات، وفي خفوت سريع في أسوأ الحالات".
الآن الناس أصبحوا عقلانيين وهم لا يسارعون في الذهاب إلى هناك. ومشهد المستوطنين العنيفين هو الوجه الآخر لنهاية طريق هذا المشروع. المستوطنات لم تعد جذابة بل هي مصدر للخجل. يجب إغلاق البسطة بسرعة. هذا هو الأمر الملح الآن.
-------------------------------------------
هآرتس 17/11/2025
اليسار يحاول الاقتراب من الكهانية
بقلم: جدعون ليفي
هذه الظاهرة تقريبا شبه مجهولة في العالم: في إسرائيل اليسار هو العقلية المحافظة، المتحجرة، المترددة، المخادعة والجبانة، بينما اليمين هو الثوري، منفلت العقال الذي لا يتساوى لسانه مع قلبه. في العادة، يؤدي تطرف اليمين إلى تشدد اليسار، ولكن في إسرائيل فالعكس هو الصحيح. فعندما يتطرف اليمين فإن اليسار يميل نحو الوسط، ويلف الغموض مواقفه، ويسير على خطى اليمين ويحاول تقليده ويخسر كل شيء.
عندما تولى دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة، لم يتأخر رد فعل اليسار: لقد أصبح المعسكر الليبرالي أكثر تقدمية. وعندما تولت الكهانية السلطة في البلاد، لم يصبح اليسار أكثر تشددا فحسب، بل حاول الاقتراب من مواقفها. وعندما تقدم حكومة نتنياهو اقتراحا ينكر قيام الدولة الفلسطينية ينضم المعسكر الآخر على الأغلب إليه، وعندما تصوت الكنيست على عقوبة الإعدام، أحد أكثر مشاريع القوانين فاشية وعنصرية، لم يكن المعسكر المعارض موجودا، والرد على الكهانية كان متعثرا، التي أصبحت أكبر حركة شعبية في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، كما لاحظت رفيت هيخت وبحق في صحيفة "هآرتس" أول من أمس، تلعب الآن ضد مرمى فارغا. بدلا من أن يرد اليسار بتشديد مواقفه هو يستجيب بالارتباك ويجعل مواقفه غامضة. اليسار المحافظ تجمد في مكانه.
لا يوجد موقف يميني متطرف لا يعتبر موقفا شرعيا، ومن جهة أخرى، لم يعد هناك يسارا يعتبر شرعيا. كل تلعثم نصف يساري هو خيانة. استمعوا إلى الاستوديوهات: لن تسمعوا صوتا تخريبيا فيها. هذا الوضع خلقه اليسار والإعلام. اقترحوا أي جريمة حرب، من التطهير إلى الإبادة، وسيتم مناقشتها باعتبارها مشروعة. اقترحوا مسار عمل أخلاقي وديمقراطي وإنساني، أو مسارا متوافقا مع القانون الدولي – سيتم إسكاتكم. اليسار والوسط اللذان كان ينبغي أن يكونا متشددين، مثلما هي الحال في أميركا، يتلعثمان خوفا. اليمين يؤيد الإبادة الجماعية والتهجير. وماذا يقترح اليسار؟.
الفظائع في الجنوب والحرب في غزة، منحتا الدعم لكل نزوة فاشية هستيرية: استيطان في غزة، ترحيل إلى السودان، إعدام، تعذيب، ضرب وتدمير. كان متوقعا أن يقدم اليسار اقتراحات مضادة لا تقل تطرفا. ولكن هذا ليس ما كان في إسرائيل. كان هناك صمت تجاه كل اليمين. سنتان لم يتبين فيهما ما إذا كان المعسكر غير اليميني مع هذه الحرب أم ضدها؛ إذا كان يعترف بوجود الإبادة الجماعية أو يعتبرها دفاعا عن النفس؛ إذا كان لديه اقتراح لحل مشكلة غزة وما هو؛ إذا كان يؤيد الحوار مع حماس وإرسال قوة متعددة الجنسيات وإطلاق سراح مروان البرغوثي وتوفير ظروف إنسانية للسجناء والرهائن الفلسطينيين؟ البقاء في غزة؟ مغادرة غزة؟ هل يؤيد منطقة عازلة؟ مجرد صمت مطبق على شفا الهاوية. كل ما لديه هو "ذهاب نتنياهو إلى البيت"، هذا كل شيء.
مع يسار كهذا، نحن لسنا بحاجة إلى يمين. أيضا لا يهم وبحق فوزه. مع يسار كهذا، قد تكون فرصة الفوز ضئيلة – من يحتاجه أصلا؟ بمجرد سيطرة الكهانية على الخطاب كان يجب طرح خطابا بديلا، خطابا لا يقل تطرفا عن اليمين. كان على اليسار أن يبني أيديولوجيا كهانية خاصة به، حادة وواضحة، لا تشمل الجرائم التي رافقت الخطاب الأصلي.
إن حربا مثل الحرب الأخيرة، كان يجب أن تنمي فينا خطابا يتناول المواضيع الرئيسية ولا ينشغل بالمواضيع التافهة. معسكر يقول نحن جربنا طريق اليمين وهي قادتنا إلى المهالك. وهاكم البديل، يجب الخروج من غزة على الفور والمساعدة في إعادة إعمارها، يجب وقف المذابح في الضفة الغربية وفتحها أمام الحركة والعمل في إسرائيل، وفتح غزة أيضا. وأن يتم اقتراح خطة لإنهاء الاحتلال والتحاور مع من هو مستعد لذلك – مع البرغوثي أولا. أن يتم اقتراح نهج يختلف عن نهج كهانا والنضال من أجله. إعادة إضفاء الشرعية على المواقف الأخلاقية – هذا بديل حقيقي.
-------------------------------------------
خدعة ترامب في الأمم المتحدة: إمبريالية أميركية تتخفى في هيئة عملية سلام
جيفري دي. ساكس؛ وسيبيل فارس* - (شير بوست) 14/11/2025
تشكل فلسطين الضحية الأبدية للمناورات الأميركية والإسرائيلية. ولا تقتصر النتائج المدمرة لهذه المناورات على فلسطين التي عانت من إبادة جماعية صريحة، بل تطال آثارها العالم العربي وما وراءه. كانت إسرائيل والولايات المتحدة دائمًا في حالة حرب -مُعلنة أو سرية- سواء كان ذلك في منطقة القرن الإفريقي، أو شرق البحر المتوسط، أو منطقة الخليج، أو غرب آسيا.
* * *
تدفع إدارة ترامب هذا الأسبوع بمشروع قرار صاغه الإسرائيليون لإقراره في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية. ويفعل هذا القرار ثلاثة أمور: إنه يرسّخ السيطرة السياسية الأميركية على غزة؛ ويفصل غزة عن باقي فلسطين؛ ويسمح للولايات المتحدة -وبذلك لإسرائيل- بتحديد الجدول الزمني لانسحاب إسرائيل المفترض من غزة -وهو ما قد يعني ببساطة: ألا تنسحب أبدًا.
هذه إمبريالية تتخفى في هيئة عملية سلام. وليس هذا الواقع مفاجئًا بحد ذاته. فمن المعروف أن إسرائيل هي التي تدير السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. لكن المفاجئ والمدهش هو إمكانية أن تتمكّن الولايات المتحدة وإسرائيل فعليًا من الإفلات بهذه المهزلة، ما لم يرفع العالم صوته بالسرعة والغضب الواجبين لإيقاف هذا المخطط.
سوف يؤسس مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن ما يُدعى "مجلس سلام" تهيمن عليه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولا يرأسه أحد آخر سوى دونالد ترامب نفسه. وسوف يُمنح هذا "المجلس" صلاحيات واسعة النطاق على حكم غزة، وحدودها، وإعادة إعمارها، وأمنها. وسوف يهمّش القرار المقترح دولة فلسطين ويجعل أي نقل للسلطة إلى الفلسطينيين مرهونًا برضا "مجلس السلام".
يشكل هذا الترتيب عودة صريحة إلى نظام الانتداب البريطاني قبل 100 عام، حيث الفارق الوحيد هو أن الولايات المتحدة ستكون صاحبة الانتداب بدلاً من بريطانيا. ولو لم يكن هذا الترتيب مأساويًا جدًا لكان مضحكًا. وكما قال ماركس ذات مرة: إن التاريخ يعيد نفسه، أولاً كمأساة، ثم كملهاة. نعم، لا شك في أن الاقتراح المطروح ملهاة، لكن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ليست كذلك. إنها مأساة من الدرجة الأولى.
وفق مسودة مشروع القرار الذي لا يُصدّق، سيُمنح "مجلس السلام" سلطات سيادية في غزة. وسوف تُترك مسألة السيادة الفلسطينية لتقدير "المجلس" الذي سيكون وحده صاحب القرار بشأن "استعداد" الفلسطينيين لحكم أنفسهم -ربما بعد 100 عام أخرى؟ وحتى الأمن العسكري في القطاع سيكون خاضعًا لـ"المجلس"، وستتبع القوات المنصوص عليها في القرار "التوجيه الاستراتيجي" الذي يمليه "المجلس" -ليس مجلس الأمن، ولا الشعب الفلسطيني.
يجري طرح هذا القرار الأميركي الإسرائيلي الآن لأن بقية العالم -باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة- استيقظت على حقيقتين. الأولى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهي ممارسة تُشاهَد يوميًا في غزة والضفة الغربية، حيث يُقتل الفلسطينيون الأبرياء لإرضاء جيش الاحتلال والمستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية. والثانية هي أن فلسطين دولة، وإن كانت سيادتها ما تزال تواجه العرقلة من الولايات المتحدة التي تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع حصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة. وقد صوتت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" هذا العام، في تموز (يوليو) ثم في أيلول (سبتمبر)، بأغلبية ساحقة لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما دفع اللوبي الصهيوني الإسرائيلي-الأميركي إلى أقصى درجات التأهب لتنتج جهوده مشروع القرار الحالي.
حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق هدفها المتمثل في إقامة "إسرائيل الكبرى"، تتبع الولايات المتحدة استراتيجية كلاسيكية قائمة على فكرة فرّق تسُد، وتمارسها من خلال الضغط على الدول العربية والإسلامية بالتهديدات والإغراءات. وعندما تقاوم دول أخرى المطالب الأميركية الإسرائيلية، يجري حرمانها من التقنيات الحيوية، وإفقادها إمكانية الوصول إلى تمويل "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، وتتعرّض للقصف الإسرائيلي، حتى في البلدان التي توجد فيها قواعد أميركية. ولا تقدّم الولايات المتحدة لأحد أي حماية حقيقية؛ بل هي تدير بدلًا من ذلك "نظام حماية" بالمعنى المافيوي، حيث تمارس الابتزاز مقابل الحماية، وتستخلص التنازلات من الدول أينما كان هناك وجود للنفوذ الأميركي. وسوف يستمر هذا الابتزاز إلى أن يقف المجتمع الدولي في وجه هذه الأساليب ويُصرّ على تحقيق سيادة فلسطينية حقيقية، وعلى التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بالقانون الدولي.
ما تزال فلسطين تشكل الضحية الأبدية للمناورات الأميركية والإسرائيلية. ولا تقتصر النتائج المدمرة على فلسطين التي عانت من إبادة جماعية صريحة، بل تطال آثارها العالم العربي وما وراءه. كانت إسرائيل والولايات المتحدة دائمًا في حالة حرب -مُعلنة أو سرية- سواء كان ذلك في منطقة القرن الإفريقي (ليبيا، السودان، الصومال)، أو شرق البحر المتوسط (لبنان وسورية)، أو منطقة الخليج (اليمن)، أو غرب آسيا (العراق وإيران).
إذا كان مجلس الأمن يريد حقًا توفير الأمن الحقيقي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فيجب ألا يخضع للضغوط الأميركية، وأن يتحرك بدلًا من ذلك بحزم في انسجام مع القانون الدولي. ويجب أن يتضمن أي قرار حقيقي للسلام أربعة بنود أساسية. أولاً، يجب أن يرحّب بدولة فلسطين كعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة، مع رفع الولايات المتحدة لحق الفيتو. ثانيًا، يجب أن يحمي وحدة أراضي دولة فلسطين وإسرائيل وفق حدود العام 1967. ثالثًا، يجب أن ينشئ قوة حماية تابعة لمجلس الأمن، تتشكل من دول ذات أغلبية مسلمة. رابعًا، يجب أن يشمل تجفيف مصادر تمويل كل الجهات المسلحة غير الحكومية ونزع سلاحها، وأن يضمن الأمن المتبادل لإسرائيل وفلسطين.
إن حلّ الدولتين هو شأن يتعلق بالسلام الحقيقي، وليس بالتصفية السياسية والإبادة الجماعية للدولة الفلسطينية، ولا باستمرار هجمات الجماعات المسلّحة على إسرائيل. لقد حان الوقت ليصبح كل من الفلسطينيين والإسرائيليين آمنين، ولتتخلى الولايات المتحدة وإسرائيل عن الوهم القاسي المتمثل في حكم الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه إلى الأبد.
*جيفري د. ساكس Jeffrey D. Sachs: أستاذ في جامعة كولومبيا ومدير "مركز التنمية المستدامة فيها"، وقد شغل منصب مدير "معهد الأرض" من 2002 إلى 2016. وهو أيضًا رئيس "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة، وعضو في "لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض للتنمية". عمل مستشارًا لثلاثة من أمناء عامين للأمم المتحدة، ويشغل حاليًا منصب "مناصر لأهداف التنمية المستدامة" بتكليف من الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وهو مؤلف كتاب "سياسة خارجية جديدة: ما بعد الاستثنائية الأميركية" A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2020)، بالإضافة إلى كتب أخرى مثل: "بناء الاقتصاد الأميركي الجديد" Building the New American Economy (2017)، و"عصر التنمية المستدامة" (2015) The Age of Sustainable Development، مع بان كي-مون.
*سيبيل فارس Sybil Fares: مستشارة ومتخصصة في سياسة الشرق الأوسط والتنمية المستدامة في "شبكة حلول التنمية المستدامة".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Trump’s Ploy at the UN Is American Imperialism Masquerading as a Peace Process
-----------------انتهت النشرة-----------------