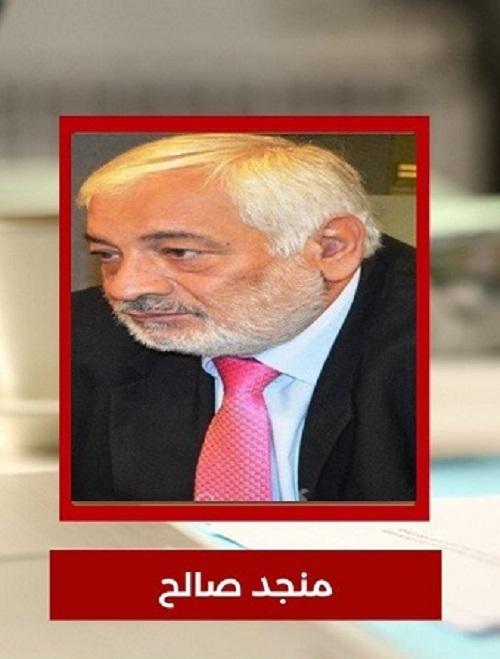الفجوة السياسية: بين قلاع السلطة وخرائب غزة!

في قلب غزة، حيث تختلط رائحة البحر بوهج البارود، تتشكل صورة سياسية مشوشة تعكس فجوة متسعة بين من يعتلون منصات القرار ومن يكتوون بنار الواقع اليومي. هذه الفجوة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية، وصراعات أيديولوجية، وانكسارات أخلاقية، جعلت من المسافة بين السياسي والمواطن مساحة رمادية يملؤها الصمت، وفقدان الثقة، وشعور عميق بالغربة داخل الوطن نفسه.
الفلسفة السياسية تخبرنا أن الحاكم، أيًّا كان شكله، لا يُبرَّر وجوده إلا بقدر ما يحقق الصالح العام، ويحافظ على العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب. لكن في غزة، يبدو أن العقد الاجتماعي تمزق تحت ضغط الحصار، والحروب، والمناكفات الفصائلية، حتى صار السؤال الأبرز: لمن يدين السياسي بولائه الفعلي؟ هل هو للشعب الذي يعاني الجوع والتشريد، أم للخطاب الأيديولوجي الذي يبرر التضحية بالممكن من أجل وعد بعيد المنال؟
الواقع يكشف أن الفجوة ليست فقط في القرارات، بل في اللغة ذاتها. السياسي يتحدث بلغة "المشاريع الاستراتيجية" و"الصمود التاريخي"، "الخسائر التكتيكية" بينما المواطن يتحدث بلغة "لقمة العيش" و"الأمان لأطفاله". هنا تتجلى مفارقة مؤلمة: ما يعدّه السياسي انتصارًا، قد يراه المواطن خسارة شخصية ثقيلة، وما يراه المواطن مكسبًا بسيطًا، قد يعتبره السياسي تنازلًا لا يُغتفر. هذه المفارقة تحوّل الحوار بين الطرفين إلى حوار طرشان، حيث الكلمات نفسها تحمل معاني متناقضة.
ومن منظور فلسفي أعمق، يمكن القول إن الفجوة في غزة تحمل بعدًا وجوديًا. السياسي يعيش في فضاء التصور، حيث المعركة الكبرى هي معركة الرموز والمعاني، أما المواطن فيعيش في فضاء الضرورة، حيث المعركة اليومية هي معركة الخبز والماء والكهرباء. وهنا يظهر التوتر بين "الحرية السامية" التي يرفع السياسي شعاراتها، و"الحرية الملموسة" التي يطلبها المواطن: حرية أن يعيش دون خوف، أن يضمن تعليم أبنائه، وأن يختار مسار حياته بعيدًا عن الإكراه.
الأخطر أن هذه الفجوة تخلق حالة من الاغتراب السياسي، حيث يشعر المواطن أن السلطة، مهما رفعت من شعاراته، ليست انعكاسًا حقيقيًا لإرادته. في الفلسفة الهيغلية، الاغتراب يعني أن الإنسان يفقد صلته بجوهره، وفي الحالة الغزية، يفقد الشعب صلته بسلطته، فيراها كيانًا غريبًا لا يمثله بالكامل، بل يفرض عليه سرديته الخاصة. هذا الاغتراب لا يولد فقط اللامبالاة، بل قد يفتح الباب أمام التمرد أو الانسحاب من الفعل السياسي برمته.
كما أن الانقسام السياسي الداخلي يضاعف الفجوة. فكل طرف يسعى لتوظيف معاناة الناس في معركته ضد الطرف الآخر، بينما تُركت القضايا الجوهرية، كالإصلاح السياسي، والمساءلة، والشفافية، على هامش الأجندة. وهكذا يتحول الشعب إلى "موضوع" للسياسة، لا "فاعلًا" فيها، فتُختزل إرادته في صندوق اقتراع مؤجل، أو في حشود جماهيرية تستدعى عند الحاجة، ثم تُترك لتواجه مصيرها.
الفلسفة الأخلاقية تلزم السياسي بأن يكون صادقًا مع شعبه، وأن يوازن بين المثال والممكن، لكن الواقع الغزي يظهر أن المثالية السياسية قد تحولت أحيانًا إلى غطاء للعجز عن تحقيق الممكن، وأن الواقعية الشعبية تصطدم بجدار الخطاب الذي لا يعترف بالهزيمة حتى في قلب الخسارة. هذه الفجوة الأخلاقية قد تكون أخطر من الفجوة المعيشية، لأنها تزرع في النفوس شعورًا بأن السياسة لعبة مغلقة لا مكان فيها للمواطن العادي إلا كرقم أو صورة في نشرات الأخبار.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا. فالتاريخ يعلمنا أن الفجوات بين الشعوب وسلطاتها قد تضيق إذا توافرت إرادة حقيقية لإعادة بناء العقد الاجتماعي، على أساس الاعتراف المتبادل بالكرامة الإنسانية، والمشاركة الفعلية في القرار، وشفافية الغايات والوسائل. في غزة، لن تُردم هذه الفجوة بخطابات النصر ولا بوعود المستقبل البعيد، بل بقرارات ملموسة تضع حياة الناس في مركز الاهتمام، وتعيد للسياسة معناها الأصلي: خدمة الإنسان، لا استخدامه.
إن الفجوة السياسية في غزة ليست قدرًا محتومًا، لكنها أيضًا ليست جرحًا يلتئم تلقائيًا. إنها امتحان أخلاقي وفلسفي لكل من يمارس السلطة أو يواجهها، امتحان يُسأل فيه السياسي: هل أنت ممثل لشعبك أم وصي عليه؟ ويُسأل فيه الشعب: هل ستبقى متفرجًا على مسرح السياسة، أم ستعيد كتابته؟ في الإجابة عن هذين السؤالين، قد نجد الطريق إلى جسر الهوة، وربما إلى صياغة حكاية جديدة، أقل وجعًا وأكثر صدقًا.